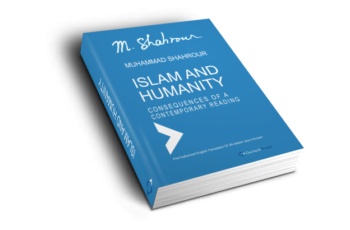تتمة بحث الإسلام والإيمان (2) – مجلة روز اليوسف
لقد أنهينا مقالنا السابق بسؤال هو: هل ما يسمى بالصحوة الإسلامية هو فعلاً كذلك؟ وقد أعطينا فكرة في المقال عن الإسلام والإيمان. ولنوضح مفهوم الصحوة نقول ما يلي:
أول مؤشرات الصحوة هو وعي أن حرية الاختيار بين الخير والشر والفجور والتقوى والطاعة والمعصية هي كلمة الله التي سبقت لأهل الأرض جميعاً وقامت المساءلة طبقاً لهذه الحرية.
فنحن نطيع الله بملء إرادتنا، ونعصيه بحرية اختيارنا. وإن الجهاد في سبيل حرية الاختيار لأي إنسان على الأرض بغض النظر عن ملته وعقيدته هو الجهاد في سبيل الله، وقد تأخذ شكل العنف في بعض الشروط الموضوعية، وتأخذ أشكال كثيرة أخرى غير العنف. فالبلاد التي يساق فيها الناس إلى المساجد بالعصا وتُحَجَّب فيها النساء بالقوة فإن كلمة الله فيها هي السفلى، والبلاد التي تمنع فيها الصلاة ويمنع فيها الحجاب بالإكراه فإن كلمة الله فيها هي السفلى أيضاً. وكلما تقلصت مساحة حرية الاختيار عند شعب من الشعوب ازداد قرباً من المملكة الحيوانية وازداد بعداً عن الله، لأن الله حر ونحن متحررون، والله عليم ونحن متعلمون، وهذا هو معنى قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} أي يكونوا عباداً لي يطيعونني بملء إرادتهم ويعصونني بحرية اختيارهم. وهذه الآية لا علاقة لها بصوم أو زكاة أو حج.
فالناس عباد الله وليسوا عبيد الله. فالعباد لهم حرية الاختيار ابتداء من الحرية الشخصية وانتهاء بالحرية السياسية وما بينهما، والعبيد ليس لهم حرية الاختيار. ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خير تعبير عن إعلان أن كلمة الله هي العليا. ومن هذه الحرية تنتج التعددية واختلاف وجهات النظر وتنتج جدلية المجتمعات قاطبة. وعلينا ترسيخ قيمة الحرية في الضمير الإسلامي على أنها القيمة العليا وهي قبل العدالة. فالأحرار (عباد الله) يستطيعون أن يقيموا العدالة، والعبيد لا يقدرون على شيء.
إن مفهوم العبودية على أنها لله الذي نسمعه صباح مساء رسَّخ في أنفسنا الذل والضِّعَة والصِّغار. وأصبحت هذه الصفات ضمن عقليتنا وثقافتنا، فالله لم يطلب العبودية من أحد وإنما هي العبادية. ونحن عباد الله في الدنيا، وعبيده يوم الحساب لانتفاء الخيارات هناك. وإن ترسيخ ثقافة العبودية حوَّلَ الناس من مجتمعات إنسانية إلى قطعان قابلة للإنقياد من قبل المستبدين الطغاة.
بما أن الإسلام دين الفطرة ويحمل الطابع العالمي الإنساني فنحن نحقق الصحوة الإسلامية بالأمور التالية:
- – في كل بلد دخل الفرد فيه مرتفع والبطالة فيها قليلة، فإن الإسلام بخير، وكل من يعتقد أن أرزاق الإنسان مكتوبة سلفاً فهو واهم طبقاً لآيات التنزيل الحكيم.
- – في كل بلد العناية الصحية فيه متوفرة من طب ومشافي بهدف إطالة عمر الإنسان ليعيش بصحة جيدة فالإسلام بخير، وكل من يعتقد أن الأعمار مكتوبة على الناس سلفاً فهو واهم، لأنه طبقاً للتنزيل الحكيم فالأعمار غير ثابتة.
- – في كل بلد القضاء فيه نزيه، وشهادة الزور فيه قليلة ونادرة وعقوبة شهادة الزور والفساد والرشوة عالية فالإسلام بخير.
- – في كل بلد يكون فيه الاعتناء بالمياتم والأيتام مهما كانت ملتهم وأصلهم وفيه جمعيات خيرية كثيرة فالإسلام بخير.
- – في كل بلد مواصفات الإنتاج متقدمة ودقيقة، ومخالفة المواصفات نادرة وعقوبة مخالفتها شديدة، والمواد الغذائية والمواد الترفيهية والرياضية متوفرة، فالإسلام بخير.
- في كل بلد علاقات الحلال فيه بين الذكر والأنثى متوفرة وسهلة، وانتقال الثروة بين الأفراد بالوصية لا بعلم الفرائض المزعوم فالإسلام بخير.
وبكلمات مختصرة: إن أحسن وسيلة للتعبير عن الصحوة الإسلامية وقيم الإسلام هي منظمات المجتمع المدني ابتداء من الجمعيات ومروراً بالنقابات وانتهاء بالأحزاب السياسية. وقد فشل السادة العلماء الأفاضل في تقديم الإسلام والإيمان إلى العالم بشكله العالمي والإنساني. بل أصروا على قيم العبودية والآخرة لأنه لا يوجد عندهم ما يقدموه للناس في هذه الدنيا. وكذلك فشلت الحركات الإسلامية السياسية في برامجها.
أما الصحوة الإيمانية فتتمثل بما يلي:
- إذا زاد عدد صائمي رمضان فالإيمان بخير.
- إذا زاد عدد دافعي الزكاة وزادت قيمة الزكاة فالإيمان بخير، وبما أن الزكاة عمل اجتماعي له علاقة بالغير ليس كالصلاة والصوم والحج فهناك زكاة الإسلام وزكاة الإيمان.
- إذا زاد عدد مقيمي صلاة الجنازة فالإيمان بخير.
- حب الرسول (ص) من الإيمان.
أي نختصر الإيمان والإسلام بالجملتين التاليتين:
كل فضيلة وعمل صالح وإيجابي ليس وقفاً على أتباع الرسالة المحمدية هو من الإسلام، وهذه الفضائل لا علاقة للسنة النبوية بها، لأن الناس عرفوها دون أن يؤمنوا برسالة محمد (ص) ودون أن يدروا بهذه الرسالة، وعرفوها قبل ومع وبعد هذه الرسالة.
كل فضيلة وعمل صالح لا يقوم به إلا أتباع الرسالة المحمدية فهو من الإيمان. والإيمان تابع للإسلام وبعده لا قبله. وإن الأطروحة التي تقول أن الإسلام يجبُّ ما قبله غير صحيحة لأنه لا يوجد شيء قبل الإسلام وإنما الصحيح هو (الإيمان يجبُّ ما قبله) لذا قال في سورة محمد بأن الذين دخلوا في الإيمان برسالة محمد بعد الإيمان بالله {كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم}. وهنا نلاحظ أمراً هاماً هو أن الإسلام بعد الإيمان بالله واليوم الآخر مجاله الدنيا حصراً، وهو طريق الآخرة. أما الإيمان مع أركانه فلا علاقة له بالدولة وبالمنظمات المدنية، وإنما هو مرتبط بالمجتمع فقط. وهنا نفهم معنى فصل الدين عن الدولة. وإن قال قائل: أين الأحكام من عقوبات وإرث وزواج؟ فأقول سأفصّلها في حينها.
فإذا أخذنا بلدا مثل مصر مثلاً، ووضعنا المقاييس المذكورة أعلاه وقارنا الأحوال ما بين عام 1970 وعام 2004 فأننا نحكم بسهولة أن الإسلام تراجع وزادت الغفوة، لا الصحوة، وإنه في بلاد كثيرة من التي لا تسمي نفسها بلادا إسلامية الإسلام فيها بخير أكثر مما هو عندنا بكثير.
أما الصحوة التي نراها فهي صحوة إيمانية وهي لاتسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لبناء الدول والحضارات، لأن الفائدة منها فردية أخروية. وهكذا نرى أن التركيز في البرامج الدينية يتم على الشعائر والذكر والتلاوة والدعاء والجنة والنار والموت. وأصبح الإنسان الذي يحب الحياة ويكره الموت يشعر أنه مذنب ويستغفر الله، وأصبحت ثقافة الموت هي الشائعة عوضاً عن ثقافة الحياة. وكذلك التركيز على شعائر الإيمان لا يضر المستبدين في شيء ولا يهددهم مثقال ذرة.
الإجرام والمجرمون
إذا أردنا تعميق فهمنا للإسلام والمسلمين في التنزيل الحكيم، فما علينا إلا أن ننظر في تعريف المصطلح المضاد للإسلام وهو الإجرام، والمصطلح المضاد للمسلمين وهو المجرمين في قوله تعالى:
{أفنجعل المسلمين كالمجرمين * مالكم كيف تحكمون} القلم 35، 36.
لقد ورد الأصل “جرم” ومشتقاته 67 مرة في التنزيل الحكيم. وهو أصل واحد في اللسان العربي يعني القطع. ومنه سميت الأجرام السماوية أجراماً لأنها منفصلة مقطوع بعضها عن بعض. ومنه جاء قوله تعالى: {لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون} النحل 109، أي أن خسارتهم في الآخرة أمر مقطوع ومبتوت به.
وإذا كان المصطلح القانوني المتداول اليوم، يسمي السارق والقاتل والغاصب مجرماً، فإن الأصل في ذلك أن المجرم هو الذي قطع صلته بالمجتمع وقوانينه وانطلق يجري على هواه. تماماً كالمجرم في التنزيل الحكيم، الذي قطع صلته بالله، فأنكر وجوده، وكفر باليوم الآخر، وكذب بالبعث والحساب. وهو ما نطلق عليه بمصطلحنا المعاصر اسم الملحد”.
ونقرأ قوله تعالى:
- {.. ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون} القصص 78.
- {وامتازوا اليوم أيها المجرمون} يس 59.
- {ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون} الروم 12.
- {يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام * فبأي آلاء ربكما تكذبان * هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون} الرحمن 41، 42، 43.
- {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين} النمل 69.
- {كذلك نفعل بالمجرمين * ويل يؤمئذ للمكذبين} المرسلات 18، 19.
ونحن هنا مع الآيات أمام صور تصف مجرمين ينكرون البعث، ويكفرون بوجود الله، ويكذبون باليوم الآخر، قاموا من أجداثهم بعد نفخة الصور الثانية، فرأوا رأي العين ما كانوا يكذبون بوجوده، فبهتوا دهشة، وبان ذلك على وجوههم، إلى حد لا يحتاجون معه إلى سؤال وجواب، فهم يؤخذون بدلالة ما ارتسم على وجوههم، ليصلوا النار التي كانوا بها يكذبون.
أما لماذا لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، فسببه واضح تماماً. أولاً لأن المجرم إنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله، وهذا وحده كاف لأن يعطيه تذكرة مرور إلى جهنم دونما حاجة إلى ميزان أو حساب، إذ ليس له بالأصل أي كشف حساب مفتوح عند الله بحكم قطعه لصلته به. ثانياً لأن الذنوب مع الله كترك الصلاة وإفطار رمضان وإخسار الكيل وتطفيف الميزان، ذنوب قابلة للأخذ والرد والتكفير والمغفرة، لو أن صاحبها آمن مبدئياً بالله واليوم الآخر. أما مع المجرم فلا حاجة للسؤال عن الذنوب، وقد تحقق الإجرام بالله والتكذيب بيوم الدين، وقطع الصلة مع الله واليوم الآخر.
ومن هنا.. من قولنا بقطع الصلة.. نفهم قوله تعالى:
- {إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين} المدثر 39-46.
الصورة هنا لأصحاب اليمين في الجنة، يسألون المجرمين ماذا أوصلكم إلى النار؟ فيجيب المجرمون: لأننا لم نعتنق الإسلام نظرياً وعملياً. لم نسلّم بوجود الله فقطعنا صلتنا به {لم نك من المصلين} ولم نسلّم باليوم الآخر {وكنا نكذب بيوم الدين}، ولم نقدم عملاً ينفع الخلق {لم نك نطعم المسكين} بل عملنا ما يسيء ويضر {وكنا نخوض مع الخائضين}، إلى أن رأينا يقيناً كل ذلك حاضراً، فانتهينا إلى ما ترون.
ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المصلين في الآية هم مقيمو الصلاة، إلا أننا حين رجعنا إلى آيات التنزيل الحكيم، لم نجده يطلق اسم المصلين على القائمين بالصلاة هذا من جهة، من جهة أخرى ترك الصلاة أو الصيام لا علاقة له بالإيمان بالله واليوم الآخر، ومرتكبوها ليسوا مجرمين، بحيث ينطبق عليهم وصف التنزيل الحكيم. نقول هذا ونحن نستذكر قوله تعالى: {أرأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي يدعّ اليتيم * ولا يحضّ على طعام المسكين * فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين هم يراؤون * ويمنعون الماعون} سورة الماعون.
فالشبه كبير بين سورة المدثر وسورة الماعون، لأن التكذيب بيوم الدين كالكفر بوجود الله، يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الإجرام، ولهذا فنحن أميل إلى أن المقصود في السورتين بالمصلين، هو الصلة وليس الصلوة، وأميل في فهم الآيات على النحو الذي أسلفناه، لأن لنا في المصلين ومقيمي الصلاة قولاً نفصله فيما بعد.
ونعود إلى سورة المدثر وإلى قوله تعالى: {قالوا لم نك من المصلين}.
لقد قلنا إننا نميل إلى اعتبار المصلين في الآية من الصلاة الصلة وليس من الصلوة الركوع والسجود، وذلك بدلالة ما سلف قوله، مضافاً إليه أمرين:
1 – يقول تعالى في سورة المدثر الآية 26: {سأصليه سقر}. والمقصود هو الوليد ابن المغيرة، الذي أدبر واستكبر حين سمع التنزيل الحكيم، وقال إنه سحر من قول البشر.
والوليد بن المغيرة بحسب المصطلح القرآني مجرم كافر بوجود الله منكر ليوم القيامة مكذب بالبعث، والله سبحانه سيصليه سقر لهذا السبب. فحين يسأل أصحاب اليمين المجرمين ما سلككم في سقر، فإننا نفهم بأن الوليد من بين هؤلاء المجرمين الكافرين بوجود الله المكذبين بيوم الدين !! ونرى من السطحية بمكان أن يجيب الوليد بأن سبب دخوله النار، هو أنه لم يكن من مقيمي الصلوة.. إذ لا تعد الصلوة بجانب الإجرام شيئاً مذكوراً.
2- لا خلاف في أن سورة المدثر وسورة الماعون من السور المكية، بينما نزلت الصلوة في المدينة المنورة (أو في المعراج كما يقولون (؟)) وحدث هذا في آخر المرحلة المكية بعد سورة المدثر. فكيف يعقل أن يعتبر الوليد نفسه تاركاً لأمر لم يعاصر التكليف به، بل والأكثر من ذلك، أن يعتبرها أحد أسباب دخوله النار. علماً أنه في ذلك الوقت لم يكن الصحابة أنفسهم قد أقاموا الصلوة.
إن للمجرمين في التنزيل الحكيم صفات مميزة يعرفون بها:
- فهم لا يخفون أنفسهم {يعرف المجرمون بسيماهم..} الرحمن 41.
- ويضحكون من المسلمين المؤمنين بالله واليوم الآخر ويستهزئون بهم {إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون} المطففين 29.
- وقطعوا كل صلة لهم بالله، بدلالة تسميتهم مجرمين.
- ليس لهم وقفة أمام الله في الآخرة، وليس لهم كشف حساب مفتوح عنده، إذ ليس مع الإجرام ذنب {.. ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون} القصص 78.
- المجرمون المكذبون المستهزئون حصة الله تعالى في الحياة الدنيا، لقوله:
- {فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} القلم 44.
- {إنا كفيناك المستهزئين} الحجر 95.
وهذه الصفات التي اختاروها لأنفسهم، هي التي تدخل بهم إلى أعمق وديان جهنم، وتميزهم عن المسلمين المؤمنين الذين شاب صلوتهم المكتوبة سهو أو غفلة لسبب أو لآخر.
وهكذا نرى أن قوله تعالى: {فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون} تعني المسلم الذي انتقل من حالة الإسلام إلى حالة الإجرام، أي أنه كان مسلماً فانتقل إلى الإلحاد، ولا تعني مطلقاً المتقاعس عن أداء الصلوات الخمس.
ونختم مقالنا بقولنا إن الإسلام لا يتم إلا بالصلة بالله (الإيمان بالله واليوم الآخر) وقد ورد ذلك في قوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} الأنعام 162، 163.
نلاحظ في آيتي الأنعام أن الصلاة جاءت من الصلة وجاء في آخر الآية ذكر المسلمين. أما قوله: {.. وأنا أول المسلمين} فتعني أن الإسلام الذي بدأ بنوح آل إلي، أي انتهى بي، وإلا فكيف يكون نوح من المسلمين وإبراهيم أبا المسلمين ثم يصبح محمد أول المسلمين؟ هنا الأول بمعنى النهاية والمآل. وهذا ينطبق مع قوله تعالى:
وأنا أول المسلمين ===> اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وأنا أول المسلمين ==> ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
كما ورد في سورة المعارج وهي مكية قوله تعالى:
- {إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا * إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون} المعارج 19-23. وكذلك قوله تعالى:
- {والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون * أولئك في جنات مكرمون} المعارج 33-35. ونلاحظ أن الصلاة جاءت في الحالتين من الصلة وليس من الصلوة، لأن سورة المعارج من السور المكية.
المصلون ومقيمو الصلاة:
لقد رأينا أن من الضروري توضيح معنى الصلاة، جرياً وراء التوفيق ورفع اللبس بين قوله تعالى في سورة الماعون {فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون} واعتبار هذا القول موجهاً للمتقاعس عن أداء الصلاة بأوقاتها، كما ترى كتب التفسير، وبين قوله تعالى في سورة المرسلات {ويل يؤمئذ للمكذبين * … * كذلك نفعل بالمجرمين}.
واللبس يتلخص في أن الله سبحانه يتوعد المؤمن المتقاعس عن الصلاة بالويل {وهو واد سحيق من وديان جهنم}، ويتوعد به في ذات الوقت المجرمين المكذبين. ومن المستحيل أن يستوي في عدل الله سبحانه المسلم المؤمن المقصر في أداء الشعائر، والمكذب المجرم الكافر بوجود الله والمنكر للبعث ولليوم الآخر، وهو الذي يقول في محكم تنزيله:
- {أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون} القلم 35، 36.
والحل في رأينا، يكمن في مفهوم الصلاة ذاتها. فقد وردت الصلاة في التنزيل الحكيم بمعنيين محددين يختلف أحدهما عن الآخر في الشكل، ويلتقي معه في المضمون، فالصلاة في الحالتين صلة بين العبد وربه أساسها الدعاء. ولكن هذه الصلة أخذت منذ إبراهيم شكلين هما:
- صلة بين العبد وربه قالبها الدعاء، لا تحتاج إلى إقامة وطقوس، يؤديها كل إنسان له بالله صلة على طريقته الخاصة. (وقد وردت في التنزيل الحكيم “الصلاة” بالألف). ومن يقوم بها هو من المصلين، إذ يكفي أن تقول (يا رب ساعدني) أو تقول (سبحان الله وبحمده) حتى تكون من المصلين.
- صلة بين العبد وربه، لها طقوس وحركات محددة خاصة بها، كالقيام والركوع والسجود والقراءة، وتحتاج إلى إقامة، أي على الإنسان أن يقوم ليؤديها. (وقد وردت في التنزيل الحكيم “الصلوة” بالواو). وهي من شعائر الإيمان.
فإذا أردنا أن نفرق بين كل من هذين المعنيين في التنزيل الحكيم، فما علينا إلا أن ننظر في قوله تعالى:
- {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والإبصار} النور 37. هنا الصلوة (بالواو).
وفي قوله تعالى:
- {ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون} النور 41. هنا الصلاة (بالألف).
ونلاحظ أن الصلوة وردت في الآية الأولى بالواو، وبعد فعل الإقامة، ونفهم هنا أنها بمعنى القيام والركوع والسجود، أما في الآية الثانية، فقد وردت الصلاة بالألف (صلاته)، والحديث فيها عن الطيور. ولما كنا نعلم أن الطيور لا تقيم الصلوة الطقسية المحددة بالركوع والسجود والقيام والقعود، فإننا نفهم أنها هنا بمعنى الصلة مع الله. وهي صلة تسبيح ودعاء يعلمها الطير ولا نعلمها نحن، لولا أن أخبرنا تعالى بوجودها.
نخلص إلى أن التنزيل الحكيم قد ميز في النطق سماعاً من جبريل وفي الخط كتابة بعد التدوين، بين الصلوة والصلاة. ليدلنا على وجوب تمييز المعنى المقصود من الأولى وأنها القيام والقعود والركوع والسجود، والمعنى المقصود من الثانية وأنها صلة تسبيح ودعاء تنبع من إقرار بوجود صلة بين العبد وربه. فإذا وقفنا أمام قوله تعالى:
{إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب 56
وفهمنا أن فعل “يصلون” وفعل “صلوا” هو من الصلوة، يصير معنى الآية أن الله وملائكته يقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون على النبي، سبحانه وتعالى علواً كبيراً. وأن على الذين آمنوا أن يركعوا ويسجدوا أيضاً على النبي.
ولكن الفعلين في الآية من الصلاة، أي الصلة، فيصبح معنى الآية أن هناك صلة بين الله وملائكته من جهة، وبين النبي من جهة ثانية، وأن الله يطلب من المؤمنين أن يقيموا صلة بينهم وبين النبي، قال بعضهم إنها الدعاء. وأنا أرى أنها أكثر من ذلك، ففي أذان الصلوة ذكر لله والرسول، وفي القعود الأوسط والأخير ذكر للنبي ولإبراهيم. ذكر النبي لأنه أبو المؤمنين، وذكر إبراهيم لأنه أبو المسلمين.
وأرى أن الله وملائكته يصلون على النبي، والمطلوب منا نحن أن نصلي عليه ونسلم. ومن هنا فإن من الخطأ الفاحش أن نقول “اللهم صل وسلم على محمد” أو أن نقول “صلى الله عليه وسلم” لأن الله يصلي على النبي ولا يسلم، والمطلوب منا نحن أن نصلي ونسلم.
فالقاسم المشترك بين الله وملائكته من جهة، والمؤمنين من جهة أخرى هو الصلاة على النبي، إلا أن ثمة خصوصية للمؤمنين فقط هي التسليم، ولهذا قال: {.. وسلموا تسليما} ولم يقل {وسلموا سلاما}. أي أن علينا نحن المؤمنين أن نسلم بوجود هذه الصلة بين الله وملائكته والنبي، وبيننا نحن وبين النبي فالتسليم هو الإذعان والقبول بلا قيد ولا شرط، كما في قوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً * وسبحوه بكرة وأصيلا * هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما} الأحزاب 41، 42، 43.
الله وملائكته هنا يصلون على المؤمنين.. فهي ليست صلوة، بل صلة وصلاة عمودها الهدى وقائمها الرحمة. ونتابع قوله تعالى:
- {إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} الأحزاب 56.
الله وملائكته هنا يصلون على النبي، باعتبار النبي من المؤمنين الذين خاطبتهم الآية 43، ثم يأتي أمر الله للذين آمنوا أن يصلوا هم أيضاً عليه ويسلموا تسليما.
ويقف المؤمنون حائرين.. لأن صلاة الله وملائكته على النبي هدى ورحمة، وهم لا يملكون للنبي هدى ولا يملكون له رحمة.. فكيف يصلون عليه؟.. وتنزل الآيتان بعدها مباشرة:
– {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا * والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوه فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا} الأحزاب 57، 58
هنا اتضحت الصورة وتلاشت الحيرة وانكشف اللبس. فالله وملائكته يصلون على المؤمنين رحمة وهدى، ويصلون على النبي باعتباره من المؤمنين أيضاً رحمة وهدى، وهذا كله منسوباً إلى الله ومن زاويته. أما من زاوية المؤمنين، فهم مأمورون بالصلاة على النبي. لكن النبي بالنسبة إليهم رسول، وإذا ما أمرت الآية 58 بكف الأذى مطلقاً وبكل أنواعه عن المؤمنين والمؤمنات والنبي من بينهم، فإن الآية 57 تشير إلى أن إيذاءه كرسول أبلغ أثراً، وأشد عند الله عقاباً، فالذي يؤذي الرسول يطرد من الرحمة (التي وردت في الآية 43) في الدنيا والآخرة.
ويتعرض لما أعده الله له من عذاب مهين. أما لماذا أمرنا بالصلاة على النبي من مقام النبوة وليس من مقام الرسالة، (أي لم يقل يصلون على الرسول) فهذا أمرٌ له بحث خاص. وكذلك صلاتنا على النبي هو عدم تعريضه للأذى. وإيذاؤه يكون بالبهتان إلى ما ينسب له من أقوال، ونقول بأن أقواله هذه هي وحي، فهذا إيذاء لله وللرسول (ص)، ولا أرى أمة آذت الله ورسوله كأمتنا في القرن الأول الهجري بقدر ما انتحلوا عليه من أقوال وكلها بهتان نسبوها له ولله سبحانه.
والذين انتحلوا عليه هم من أمته وقومه، ولم يأتوا من الصين أو من بلاد الفرنجة. وقد ابتدع السادة العلماء الأفاضل علماً قائماً بذاته اسمه الجرح والتعديل وطبقات الرجال، ولكن لم يقولوا لنا لماذا ابتدعوا هذا العلم الذي لم يسبق له مثيل بهذا الحجم في التاريخ كله وهل هذا خير القرون؟
لقد ورد الأصل (صلو) ومشتقاته في التنزيل الحكيم 99 مرة، جاء لفظ (الصلوة) بالواو في 67 موضعاً منها. ونلاحظ في هذه المواضع أن الصلاة ارتبطت بالإقامة حيناً وبالزكاة حيناً أو دل سياق الآية بمعناها العام أن المقصود هو القيام والقعود والركوع والسجود، وليس الصلة.
ونقرأ قوله تعالى:
- {الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون} البقرة 3.
- {وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلوة والزكاة ما دمت حيا} مريم 31.
- {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون} المائدة 91.
أما حين تأتي مضافة فنجدها حيناً بالواو وحيناً بالألف.
- {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلوتك سكن لهم، والله سميع عليم} التوبة 103.
- {قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيا ما تدعون فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} الإسراء 110.
- لكنها في الحالتين لا تخرج عما ذكرنا. فالصلوة في التوبة، والصلاة في الإسراء هي الصلة بالدعاء، كما هو واضح.
- وكما أن فعل الصلاة والصلوة واحد، صلى / يصلي / صل/ يصلون، فكذلك الجمع منهما واحد. فالصلوات جمع الصلاة بمعنى الصلة، والصلوات جمع الصلوة بمعنى الركوع والسجود. يقول تعالى: {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون} البقرة 157.
- {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول..} التوبة 99. وهي هنا جمع الصلاة بمعنى الصلة.
- {حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين} البقرة 238.
وهي هنا جمع الصلوة وهي الركوع والسجود. ومن المفيد أن نشير استطراداً إلى أن المقصود بالصلوة الوسطى في الآية، هي الصلوة المعتدلة الخاشعة المطمئنة التي تكاملت أركانها بلا إفراط ولا تفريط، وليست صلوة العصر كما يحلو لبعض المفسرين أن يزعموا. وإن مفهوم الوسطية هو أن نكون من أحسن الأمم ولا يعني كما يقال حالة بينَ بين.
فإذا سأل سائل عن قوله تعالى:
- {قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا..} هود 87.
- {الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل واسحق، إن ربي لسميع الدعاء * رب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء} إبراهيم 39، 40.
- وهذا يعني أن الصلوة بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها كانت معروفة منذ إبراهيم.. فأين ضاعت هذه الصلوة ولم تصل إلى عهد النبي (ص)؟ نقول، لقد جاء جواب ذلك في صورة مريم بقوله تعالى:
- {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا} مريم 58، 59.
- ونفهم هنا ان صلوة الركوع والسجود التي كانت عند إبراهيم وإسماعيل وشعيب وعيسى وزكريا قد ضاعت عند الخلف من بعدهم، لكن صلاة الصلة بالله بقيت موجودة ولم تنقطع، بدليل قوله تعالى عن مشركي العرب:
- {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله..} لقمان 25.
فالمشركون يعرفون أن الخالق هو الله، وعلى هذا فقد سماهم التنزيل مشركين ولم يسمهم مجرمين، واعتبروا عبادتهم للأصنام نوعاً من الصلة مع الله في زعمهم، لقوله تعالى:
- {والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى..} الزمر 3.
وهكذا نستنتج أن المصلين هم المسلمون، فإذا أصبحوا مقيمي الصلوة فهم من المؤمنين.
والحمد لله رب العالمين…..
مجلة روز اليوسف